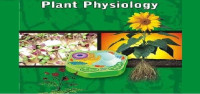«يولد الناس جهلة، ثم يجعلهم التعليم أغبياء» – بيرتراند راسل
مشاكل التعليم كثيرة أبرزها إنتاج جيل يعتقد أن الرأسمالية نوع مِن أنواع البقوليات وأنّ الفلسفة التحليلية أحد فصول السنة. مِن خلال التركيز على حفظ المعلومة لا على بناء المهارة، إذ دائمًا تُحشى الكتب والمقررات الدراسية بالمعلومات والاحصائيات والرسوم البيانية، لكنها نادرًا ما تدربك فعلًا كي تحظى بمهارة تستطيع توظيفها في سوق العمل. على العكس، غالبًا أنت ستسمع مِن أساتذة الجامعة أنك هنا فقط -في الكلية- لتأخذ الأساسيات وحسب بينما بعد التخرّج ستتدرب، وهذا بحد ذاته فشل واعتراف بأن الوظيفة الرئيسة للجامعة إذًا هي منح الشهادات الكرتونية ليس إلا.
ولكي نكون منصفين لا بد مِن الإقرار بذلك. إذ اعترف التعليم المدرسي والجامعي منذ البداية ولم يعد بالفهم أو «التمهير» بقدر وعده بالعمل والوظيفة والراتب الشهري. إذ نشأت المدارس والجامعات بشكلها المنظم المعروف حاليًا بعيد حدوث الثورة الصناعية واكتشاف نقص العمالة والتخصصات، فأدرك أصحاب الأموال أنهم بحاجة لمؤسسات تقوم بتأهيل الناس في سياقات محددة حتى يستطيعون العمل لدى الحيتان الذين يديرونها. فالنظام التعليمي بأكمله نشأ لهذا السبب، فلماذا تطلب منه أساسًا ما لم يعد به أصلًا؟
قد يسأل أحدهم، وماذا عن الجامعات القديمة؟ ماذا عن أكاديمية أفلاطون التي كتب على جدرانها: «مَن لم يكن مهندسًا فلا يدخل إلينا»؟ ماذا بشأن كل هذه الدور التعليمية؟
صحيح. لكنها لم تكن ذات انخراط حقيقي في المجتمع، فغالبية هذه الدور التعليمية المتناثرة عبر التاريخ كانت «رفاهية» يمارسها النخبة، بينما عموم الناس مشغولون في حراثة الأراضي ونقل قدور الماء كما يقول البروفيسور يوفال هراري. أي أنها لم تكن تشكل هاجسًا كبيرًا مهمًا كما الآن، لدرجة أن الطفل بعيد ولادته يُدخل إلى المدارس ويبدأ التلقين والتعليم. لا أبدًا. هذا الأمر لم يحدث إلا مؤخرًا مع انطلاق الثورة الصناعية ونقص العمالة المتخصصة فكان لا بد مِن القيام بمؤسسات تعليمية منظمة بدقة، فكانت عندها الجامعة والمدرسة.
بالمناسبة وقبل أن ننخرط في صلب المقال، لا بد مِن القول أنّ نظام الدرجات المتبع بشكل أساسي في المدرسة ومن ثم يفقد قيمته تدريجيًا مع الدخول للجامعة هو اختبار IQ معدّل طويل الأمد. نعم نعم، لم يصرّحوا بذلك مداراةً لمشاعرنا الرقيقة لا أكثر. ألم تسأل نفسك ما معنى الدرجات؟ لماذا مَن يحصّل درجات أعلى تُفتح أمامه خيارات دراسيّة أكثر؟ ألم تسأل نفسك ماذا يعني أن تأخذ بالمقرر الدراسي مئة من مئة؟ ماذا يعني هذا الرقم؟
يعني هذا الرقم قدرتك على فهم المادة إضافةً لحفظها ولذلك قلت هو اختبار ذكاء معدّل، لأن الذكاء مَنوط بالفهم والربط المنطقي، لكن المدرسة بدهائها الشديد تقوم بتعديله مع عنصر الحفظ والانضباط والقدرة على المراجعة في أوقات محددة، وعلى هذا نشأ نظام الدرجات وانتشر.
حتى في دولة عتيدة كألمانيا، يُتبع نفس هذا النظام -صححوا لي إن أخطأت في جزئية ما- وهو أن الطالب في المرحلة المتوسطة إن لم يكن مُجتهدًا لا يتأهل لدخول مدرسة النخبة Gymnasium التي ترشحه لدخول كليات القمة، بل يدخل إلى مدارس مهنية تعلمه مهارات يدوية (نجارة – حدادة – … الخ). أي المهن التي لا تتطلب ذكاءً شديدًا إنما خبرة يدوية وقدرات جسمية.
إلا أن هذه الفكرة ليست نزيهة تمامًا وسننقدها في السطور التالية أثناء عرضنا للفيلم الهندي الشهير «3 Idiots أو البلهاء الثلاثة» وهم ثلاثة طلاب يدخلون الجامعة ليعيشوا تجربة دراسية غير تقليدية، لا سيما مع صديقهم الخارج عن المألوف «رانشو» الذي قرر كسر نمطيّة نظام التعليم بكامله.
فإذًا في ضوء هذا الفيلم، سنعرض نقاط مهمة في التعليم والحياة الجامعية، كيف تغيّر العقول إيجابًا وسلبًا وكيف يمكن إصلاح ذلك، والبداية ستكون مع الأهل…
المعضلة التاريخية: حلمي أن أدرس طب
لنتفق أن الأحلام دائمًا تأخذ صيغة طفولية بريئة، فعندما نسأل طفلًا وطفلة صغيرة عن أحلامهم سنجد الأجوبة الحقيقية أقرب ما تكون لـِ: أريد أن أصبح طيارًا عندما أكبر، أريد أن أحلّق بين الغيوم، أريد أن أكون المحقق كونان، أريد أن أكون مثل سنو وايت، وطبعًا لا نغفل عن الحلم المشترك لدى الجميع وهو أن نُترك في دكان الحلوى ونُنسى. هذه هي الأحلام الصغيرة، تميل للخياليّة والتركيز على الملذات اللحظيّة.
مِن مثيرات الاستغراب أن تجد أحدهم يقول لك: حلمي أن أصبح طبيبًا! يا عزيزي هذا ليس حلم، هذه دمغة خُتمَ علينا بها عندما كنا صغار، لا يكون الحلم هكذا. لا يحمل صيغة باردة عمليّة إلى هذا الحد.
يتحدث الفيلم في مقدمته عن كيف أنّه مِنذ بداية ولادة الطفل، تجتمع عائلته الهندية فوق رأسه ليقولوا سوف يصبح أبننا مهندسًا -المهندس في المجتمع الهندي تعادل الطبيب في المجتمع العربي- فبعد أن يتم اختيار اسمك وانتقاء ملابسك وأنت صغير، يُمهر عليك فورًا بماذا يجب دارسته وتعلّمه.
لا مشكلة مع الطب، لا مشكلة مع الهندسة. المشكلة أن الاعتداء -في مرحلة مبكرة جدًا- على الطفل وايهامه بما يجب أن يكون. فيما بعد يُرى هذا التناقض الرهيب يحدث، مِن خلال سماع أحدهم يقول: حلمي أن أدرس الطب! يا صديقي. كيف حملَ حلمك صيغة جديّة لهذا الحد؟ نادرًا ما يكون الطفل على دراية بهذا الموضوع ويقرر أن يحدد بدقة حلم رسمي له مكانة اجتماعية في مرحلة مبكرة! غريب جدًا، يبدو وكأنه ليس حلمك الشخصي، يبدو كأنه فرض عليك جبرًا وأنت فقط تكرر ما تلقنته!
الحلم شيء جميل. لكنه يكون أجمل إن كان حقيقيًا وليس دمغة.
كل شيء على ما يُرام All Izz Well
لكن أن تبكي وتلطم وتنوح طيلة حياتك الجامعية أمر سيء أيضًا. وأن تندب على مدى تهافت النظام التدريسي ومحدوديّته أمر غير مفيد. لا سيما أن هذا النمط سادَ لفترة طويلة ويبدو أنه سيستمر لفترات أخرى. لكن ما الحل؟
الحل ما فعله رانشو خلال الفيلم، عندما اعتمد عبارة: «كل شيء على ما يُرام» في جميع المواقف. دائمًا كانت ما تصاحبه في المواقف الصعبة، كنوع مِن التذكير، أن كل شيء على ما يرام وكل شيء سوف يمضي. وإن أردنا توضيحها بشكل أكبر لا بد من طرح مثال اللقمة الطعاميّة.
تخيّل نفسك عندما تجلس أمام طاولة الطعام وهناك وجبة لا تحبها لكنك مُجبر على الأكل، ما الذي تفعله؟ تدخل اللقمة إلى فمك لكنك لا تقوم بمضغها، إنما فقط ترطيبها ثم تبلعها بحيث لا تشعر بطعمها ولا تعبأ بها كثيرًا.
نفس الأمر تمامًا مع الجامعة، هي مجرد مرحلة بروتوكولية لا تمضغها فقط قم ببلعها وتمريرها. وتذكر دائمًا أن كل شيء على ما يرام. في النهاية ستمضي ستمضي. لذلك لا تنوح كثيرًا، فقط مررها.
هل الحياة سباق فعلًا؟
على لسان مدير المدرسة «فيروس» في الفيلم، وحتى على لسان جميع مدراء التعليم حول العالم، ستسمع هذه العبارة، الحياة سباق خصوصًا تلك الدراسية منها، وإن لم تكن سريعًا فإن الآخرين سيسبقونك وتخسر. فهل هذا صحيح، هل الحياة سباق فعلًا؟
لا. هي سباق فئران Rat Race. لا سباق حميد إن صح التعبير. ما أهميّة أن تكون في سباق لا ينتمي لك؟ ما أهمية أن تركب قطار يقودك إلى وجهة ليست وجهتك؟ ليذهب حينها القطار إلى الجحيم. سباق تعيس يقتلك وأنت تعدو فيه هو ليس سباق ينبغي دخوله، هو كسباق يمكن تلخيصه بالصورة التالية:

لقد تغير العالم كثيرًا، كان السباق واردًا في القرن الماضي عندما كان هناك تنافس كبير على مهن محدودة. الآن أصبح العالم غاصًّا بأشياء جديدة لا تخطر على البال، إذ ولّدت الثورة المعرفية التقنية مهنًا جديدة غير تقليدية أبدًا. فالآن «الغيمرز Gamers» الذين لديهم قنوات على اليوتيوب يكسبون أكثر مما يكسبه مئة طبيب مجتمعين، حينها تقول أنّ الحياة لا سيما الدراسية سباق يجب أن تكون سريعًا كي تربح فيه؟
قديمًا نعم أو ربما، أما الآن فحتمًا لا. باستثناء إن كان طموحك هو التدريس الأكاديمي والعمل كأستاذ ومحاضر جامعي. غير ذلك هناك الكثير مِن المهن الإبداعية الجديدة موجودة، فالحياة قد تكون سباق لكنها سباق جانبي إبداعي وليس سباق مسافات طويلة للأمام لنرى مَن الأسرع!
تخيّل مثلًا أن يقوم أحدهم الآن في 2020 ببرمجة موقع كالفيسبوك، ما أهميته؟ لا شيء. لأن الفكرة الإبداعية خاصته قد انتهت مع 2004 عندما نفذها مارك زوكربيرغ. فالمهم ليس السباق بقدر النظر لما يحتاجه وينقصه العالم كما فعل زوكربيرغ، فتعمل على تنفيذه.
ربما تحتاج لأفكار إن أردت، هذه بشكل سريع تدور في رأسي:
- مثلاً تطبيق طبي يتيح التواصل بين الطبيب والمريض أونلاين (كورونا أثبت أننا بحاجة لهذا فعلاً).
- برنامج موسّع لإدارة العيادات يتيح إمكانية التواصل (فيسبوك طبي).
وهكذا أمثلة، هناك الكثير مِن الأفكار. اخرج مِن عقليّة السباق هذه، عقلية لماذا ابن عمتك أفضل منك ولماذا بنت خالتكِ تدرس أكثر منكِ، اخرجوا مِن سباقات الفئران هذه فهي بلا نهاية. نحن بحاجة لابتكار أشياء جديدة خارجة عن المألوف، فكّر بما هو جديد، أنت لست آلة.
ما هو تعريف الآلة؟
مع اكتمال مشروع الجينوم البشري في عام 2003 والكشف عن مكوّنات الإنسان الوراثية بكاملها، أصبح الكائن العاقل عاريًا تمامًا، فهو تضافر لما يقرب مِن 25 ألف جين مُرتّبة بطريقة معينة. هو تشكيلة وراثية غير قابلة على الإطلاق للتكرار، بمعنى أن كل إنسان هو النسخة الوحيدة مِن نفسه، ومِن المستحيل أن يأتي أحد آخر مُطابق له تمامًا.
تبدأ المشكلة عندما يقوم النظام التعليمي بتنميط هذه المورثات. يدخل 1000 طالب إلى المدرسة والجامعة، كل منهم يحمل توليفة جينية مُعينة تتيح له النبوغ في حيثية ما. إلا أن النظام التدريسي يضرب بعرض الحائط كل هذا ويقصهم كلهم على قالب واحد ضمن هياكل مُتشابهة.
قد يسأل أحدهم، وماذا تريد أن نفعل؟ هل نخصص منهج دراسي لكل طالب على حِدة مثلًا؟
قطعًا لا. إنما وجبَ أن يكون هناك هامش مِن الحرية في الحركة التعليمية مِن أجل إتاحة الفرصة لهذه الاختلافات الوراثية أن تعبّر عن نفسها. فلا يمكن لأي إنسان أن يطابق الآخر تمامًا في التكوين، فكيف يطابقه بالمُخرجات! نعم هناك مقاربات وتشابهات، إلا أن التماثل التام مستحيل. فلا بد مِن هامش يخلق فسحة للتعبير عن هذه المقوّمات المعطلة والمكبلة بشروط التعليم الجامدة.
تظهر هذه الفكرة ضمن الفيلم عندما يطلب الأستاذ مِن رانشو تعريف الآلة، فيقوم رانشو بشرح الآلة لا تعريفها الحرفي، وهنا يغضب الأستاذ ويطالبه بالتعريف الحرفي الذي يأخذ عليه درجات في الاختبارات وليس التعريف «الفهمي».
الإنسان ليس آلة، الإنسان خليط مِن الـ DNA غير القابل للتكرار أبدًا على وجه الأرض، أن تقوم بقص أجنحته وفق قوالب جاهزة ذنب عظيم، جرم كبير في حق إمكانيات مُضاعة كان بالإمكان استغلالها على نحو أفضل.
ظاهرة الانتحار عند الطلاب
مِن بين كل 12 طالب في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعَ واحدٌ منهم مُخططًا للانتحار. تزداد هذه النسبة في الهند أكثر لا سيما في تخصصات الهندسة، ناهيكم طبعًا عن حالات الاكتئاب الشديدة التي تضرب ربع الطلاب تقريبًا، مما يشير لمشكلة وسوء فهم في الوقت ذاته.
تكمن المشكلة في الضغط غير القابل للاحتمال، ذلك عندما صيغت الفكرة في الفيلم بعبارة لطيفة جدًا بالقول: أنّ الطلاب لم ينتحروا بل قُتلوا! والجاني هو الضغط الكبير عليهم غير القابل للاستيعاب.
أما مِن ناحية سوء الفهم، فهو أن الجامعة وتعليمها كانت صعبة دائمًا. أي أنها لم تعدك بالسهولة والنعومة أبدًا. ولا أعتقد أن أحدٌ ما يعتقد أن فعل الدراسة بعينه بما يشمله مِن حبس في المنزل وقراءة المحاضرات وتكرارها والاستيقاظ مبكرًا، هو فعل مُسلي، قطعًا هو فعل مُجهد، لكن الإنسان يحتمله في سبيل الحصول في النهاية على شهادة تمكّنه مِن الانخراط في سوق العمل. لذلك مِن الاجحاف قليلاً وضع العبء على الجامعة لأنها لم تجبرك على الدخول أساسًا. هي منذ البداية كانت صعبة ومُجهدة. فلا تتوقع كثيرًا نعومةً منها.
لماذا يفعلها الأهل؟
بقيَ أهل «فرحان» داخل بيتهم في الحر ووضعوا المكيف الوحيد لديهم في غرفته فقط مِن أجل أن يستطيع الدراسة والنجاح في الهندسة ثمّ التوظيف ليحصل على حياة كريمة. لم يكن أهل فرحان يريدون فعل ذلك مِن أجل تحقيق رغبتهم الشخصية فحسب، الموضوع أعمق مِن ذلك، فالأهل لم يطلبوا من الابن دراسة شيء ما لأنهم يريدون رغباتهم ونزواتهم الشخصية تتحقق، إنما لأنهم يعلمون أن ذلك المجال هو ما يضمن الحياة الكريمة على التقدير الأقل.
وهذا صحيح، فالأهل هنا ينزعون منحى أخلاقي لا منحى سلطوي استبدادي. إلا أن النقطة المغفل عنها كثيرًا هو مدى التطوّر التقني الذي حدث في الفترة الأخيرة. فحتى عام 2000 كانت الطب والهندسة والتقليدي مِن المهن هي فعلاً سيدة الكسب المادي والحياة الكريمة. الآن كل شيء تغير، خلقت الثورة التقنية مهنًا كثيرة أخرى وقضت على الكثير أيضًا.
أين مهنة ساعي البريد الآن؟ أين المهن التقليدية؟ كلها شبه اندثرت. بينما ظهر اليوتيوبر ومحرر الفيديو والمصور الفوتوغرافي ومُحترفي الفوتوشوب وغيرهم كثر. هناك مقولة تنسب لسقراط ومِن بعده للإمام عليّ تقول: لا تربوا أولادكم على آثاركم، فقد خلقوا لزمان غير زمانكم. فعلى الأهل التطلّع ببصيرة نحو العالم قليلًا، ليدركوا مدى التغيرات المرعبة التي حدثت. لو كنا قبل الـ 2000 لكان جُل ما يقولونه صحيح ومُحق، لكن العالم تغيّر ومِن الأفضل لنا أن نتغير نحن أيضًا، سواءً بطريقة التفكير أو القرارات التي نتخذها.
أصدقاء السوء أوفياء دائمًا
«هناك الكثير مِن الامتحانات بينما لدينا أب واحد فقط!» كانت هذه الجملة التي قالها رانشو لـِ «راجو» عندما أخذوا والده إلى المشفى وتأخروا على الامتحان حينها. الامتحانات كثيرة تأتي وتذهب لكن والدك واحد فقط. ويمكننا أن نعمم الفكرة لتشمل الأصدقاء أيضًا.
لدينا الكثير مِن الامتحانات، بينما صديقك وصديقتك واحد فقط! قد تستغربوا مِن معرفة أن هناك استطلاع أجريَ على الجامعات الأمريكية وجدَ أنها تساهم في تعزيز الميول الليبرالية لدى الطلاب ورفع قيم الحرية والعدالة والمساواة. ويمكننا أن نعمم هذا المثال لنرى أنه يشمل جميع جامعات العالم.
ذلك لأن الطالب في مرحلة المدرسة، يكون في مدرسة محلية ضمن الحي داخل المدينة التي يسكن بها. أي أنه لا يحتك بأحد مِن خارج إطار محيطه الصغير، بينما تفعل الجامعة العكس، ويزداد هذا الفعل إن درست في بلد آخر، ذلك عندما ترى الناس مِن جنسيات مُختلفة وأماكن مُختلفة وألوان مُختلفة وعقائد مُختلفة، حينها تقول بينك وبين نفسك: العالم كبير جداً! ليس فقط أنا وقومي موجودون! هناك الكثير من الناس يعيشون على سطح هذا الكوكب، وهم مسالمون رائعون وربما أفضل مني شخصيًا!
هنا تمامًا تتعزز الميول الليبرالية لدى الطالب. وعلى العكس تمامًا نجد أن المنغلق الذي يحاكم العالم كله مِن على نافذة مكتبهِ الضيقة، غالبًا لم يكن وصل إلى المرحلة الجامعية ولم يحتك بأحد ولم يطلع على أحد ولا يضع نفسه مكان أي أحد. والمشكلة أن هذا النمط هو أكثر مَن يصدر الأحكام على الناس.
قد نبرر الانغلاقية بكونها عدم رغبة في الانفتاح، لديهم كل الحق في ذلك، لتنغلق بقدر ما تشاء. لكن أن تكون منغلق وتصدر أحكامك على الناس كأنك قد طفت الدنيا بأجمعها وتعرف الجميع في كل مكان، فهذا ادعاء ساذج لا يجرء الأسوياء على فعله.
لا تكمن فائدة الجامعة في الشهادة والمعلومات بقدر أهمية اكتساب علاقات متينة تغيّر مِن طريقة نظرك للناس ومجتمعاتهم. فتمسك بأصدقائك الذين تتعرف عليهم فترة الجامعة، فأصدقاء السوء الذين لا يدرسون هم أوفياء دائمًا، عكس أولئك الشطّار الذين يبيعون الغالي والنفيس لقاء الحصول على درجة زائدة.
نظام الدرجات والطبقية والعنصرية
ذكرت في المقدمة أن المدرسة هي بمثابة اختبار ذكاء طويل معدّل يهدف ليس للفهم الخام فحسب بل التأكد مِن القدرة على الحفظ والانضباط وبالتالي الوصول إلى تصفيات أسواق العمل والحصول على مهنة تحقق لك دخلًا جيدًا.
نقطة النقد لهذا النظام أنه قديم، أي أنه تبلور في القرن الماضي عندما كان يُعتقَد أن نموذج الذكاء الوحيد هو الرياضي المنطقي وأن الناس لا يقاسون إلا بهذا، لكن الآن الواقع تغيّر، فنظرية تعدد الذكاءات وحتى مع الذين ينقدونها بالقول أنّها تعدد مهارات وليس ذكاءات لأن الذكاء واحد، قد ساهمت في تغيير طريقة الاختيار في سوق العمل.
ماذا سأستفيد إن كنت صاحب مهنة ووظفت أذكياء غير مُدربين؟ لا شيء. على العكس ربما يفضلون توظيف إنسان عادي بخبرة جيدة. وهذا ما نفذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا عندما وقّع أمرًا باعتماد المهارة والخبرة قبل الشهادة الدراسية في التوظيف الحكومي. وهذا فعل جيد وفعال لكنه محدود جدًا.
بمعنى أن التوظيف في أمور لها علاقة بالكتابة أو التسويق أو حتى البرمجة بوصفها تنفيذ لأكواد محددة هو أمر فعلًا يتطلب المهارة لا الشهادات. لكن في أمور ضخمة كالصيدلة والهندسة الكهربائية مثلاً أنت بحاجة لتأسيس عميق تكوّنه الجامعة فيك قبل أن تحصل على الخبرة في سوق العمل.
لا يوجد أحد يملك خبرة في الصيدلة ووصل المحركات الكهربائية دون تأسيس جامعي. لذلك لا بد مِن وجود شهادة، والشهادة هنا مجاز لكونها مرحلة تراكمية مِن بناء أكاديمي يشمل طبقات متعددة مِن المعرفة في المجال المدروس. لذلك أعتقد أن بعض النقد المجحف للتعليم الجامعي يقع تحت ما يمكن تسميته:
«رفاهية الدراسة المجانية» أي أن مَن يفعله هو مَن ينتقد جامعته المجانية في العالم الثالث، أو مَن يدرس في المانيا والسويد وغيرها مِن الدول التي تدرّس بشكل مجاني. لا أعتقد أن هناك طالب دفع قسط هارفرد السنوي 20 ألف دولار وبعدها يقول: تباً التعليم الجامعي سيء! لا، هذا النقد هو رفاهية الدراسة المجانية لا أكثر.
الكارثة الكبرى المُضافة هي القول بأني أعمل وأحصل على المال فلماذا أدرس؟ على هذه المقدمة يجب علينا إغلاق كل جامعات وكليات الفلسفة والعلوم الاجتماعية والفنون لأنها لا تأتي بالأموال، فالفيلسوف قطعًا لا أحد سيوظفه. ولأعمم المثال أكبر، لو فكّر الإنسان العاقل بهذا فقط قبل عشر آلاف سنة مِن الآن لما بنى شيء اسمه حضارة مِن أصله! كان سيقول: أنا أعيش وأرعى الغنم وآكل قوت يومي، لماذا أفكّر في أمور كالفلسفة والمنطق وغيرها مِن التوجهات غير المهمة التي لا تأتي بالمآكل ولا المأوى! بنى الإنسان ما بناه مِن صروح لأنه فكر أبعد مِن حدود غرائزه البداية. فأن تقول أنّك تحصل على المال فلماذا تدرس، شبيه بأن يقول الإنسان البدائي أنا آكل وأرعى الغنم لماذا انطلق نحو المدنيّة وأبني الحضارة! هذا ارتداد كبيرة نحو الأصول الطبيعية للإنسان، فاحذر قليلًا!
عودةً لفكرتنا بعد هذا الاستطراد، هناك جانب طبقي في نظام الدرجات وهو أنه يخلق منافسة لا بد منها. بمعنى أن الطالب لا يكتفي بنجاحه بمعدل 90% فقط بل يجب على الآخرين أن يكونوا بمعدل 70%. بمعنى أنه يجب على الآخرين أن يفشلوا كي ينجح. وهو ما يسميه البعض تميّزًا. وربما الآخر يسميه طبقيّةً. ففي كل الأحوال يجب الاعتراف أن النظام التدريسي يخلق روح تنافسية، ولا يمكن أن نضفي عليها طابع الإيجاب ولا السلب، فذلك يعتمد على نقطة نظرك إليها.
الوعد الأخير: دع الأيام تفعل ما تشاءُ
الجامعة فترة بروتوكولية سوف تمر. فإن كانت سيئة بالنسبة لك سيكون الاسوأ منها هو أن تكرهها بشدة، أي أنك توليها أهمية كبيرة، فالكراهية تتطلب اهتمامًا وتركيزًا عكس اللامبالاة التي تمثل أقصى درجات السلبيّة تجاه أمر ما.
أما بالنسبة لمن سينجح في هذه الحياة ويقبض على مفاتيحها لتُفتح أمامه الأبواب، «النيرد/ Nerd/ الدحيح» الذي يدرس كثيرًا أو ذلك الذي يفضل الفهم على الحفظ الجبري، فدع الأيام تفعل ما تشاءُ ولنرى مَن سينجح في هذه الحياة -لا بد هنا مِن اعتماد تعريف للنجاح في الحياة، فلو كان النجاح هو أكبر قدر ممكن مِن الأموال، فهذا يعني أن العبقري نيكولا تسلا كان فاشلًا لأنه مات فقيرًا مديونًا- وهذا ما فعله رانشو مع الطالب الآخر «النيرد كاتم الريح» الذي تحداه بعد 15 سنة مِن نهاية الجامعة ليرى كل منهما أين انتهت به طرق الحياة وماذا قد أنجز.
لذلك حتى لو كرهتها فلا تعبأ بها كثيرًا، دع حياتك الفعليّة تثبت ذلك حقًا، تثبت أن الجامعة لم تكن مهمة، أو أنها كانت مهمة، حينها يُرى مَن الذي نجح فعلاً. فلو أردت تلخيص فكرة المقال بشيء مِن الإيجاز ستكون التالية:
الجامعة فترة بروتوكولية لا بد منها، يمكن الاستغناء عنها لصالح المهارة في بعض الاختصاصات العامة لا سيما إن كان هدفك مادي فقط، إلا أنه حتى هذا الاستغناء يعتمد على شخصية الإنسان المتبني له، فإن كان الهدف مِن كل شيء هو تحصيل المال وأن تعيش، فامشِ في طريقك ولا تلوي.
بينما في بعض الأمور الأخرى الرصينة (الصيدلة – الفلسفة – جراحة المخ والأعصاب – المعاهد الطبيّة البحثية – التخصصات الهندسية خصوصًا تلك التي تدخل في تصنيع الأسلحة) سيبقى للجامعة أثر كبير، على العكس بل ستتلقى الكثير مِن الدعم أيضًا، لا سيما أننا نعيش في زمن فيروس كورونا، ولعل العالم فيما سيأتي سيخصص ميزانيات وأموال للجامعات والمعاهد الطبية، بقدر تخصيصه للميزانيات العسكرية مِن دفاع وتسليح.
لعلَ التغيير القادم يكمن فقط في أن الجامعة ستصبح أكثر نخبويةً واهتمامًا بالأمور الحقيقية التي تحتاج لإنتاج أبحاث وتمويل، أما تلك التخصصات العادية التي يستطيع أي أحد ممارستها (الكتابة غير الإبداعية – الترجمة – البرمجة … الخ) فمن الطبيعي أن تنسحب منها الجامعة تدريجيًا وتصبح الخبرة والمهارة أفضل مِن الشهادة. وغالبًا حتى الخبرة والمهارة ستنسحب منها في السنين القادمة لأنها ستصبح مؤتمتة ينفذها ذكاء صناعي، وهذا ما يُرى في النماذج الجاهزة لكثير مِن واجهات المواقع والتطبيقات وحتى المقالات الرديئة مِن نمط عشر خطوات لتقشير البطاطا المسلوقة.
حينها يبقى الأهم مِن هذا كله أن تدع الأيام تفعل ما تشاءُ، لترى نتيجة اختياراتك قد عادت إليك. هي حياتك يا صديقي، ارسمها بالطريقة التي تريدها.